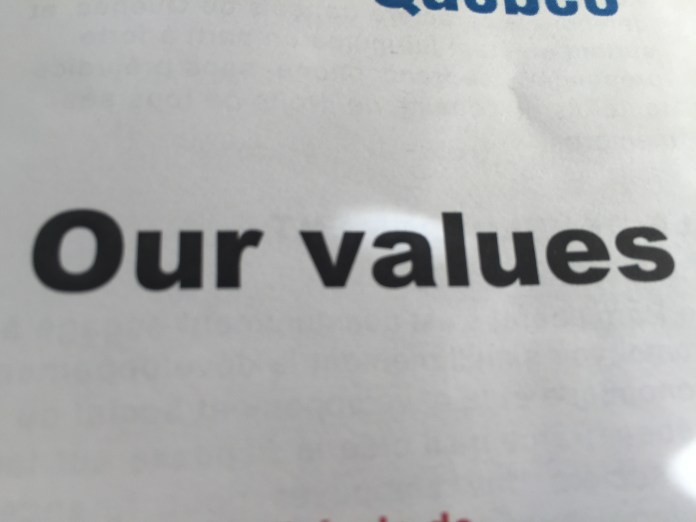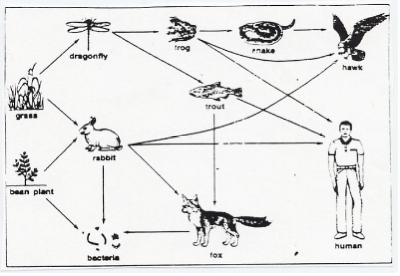في صيف ١٩٨٤ كانت ذيول الإحتلال الإسرائيلي للبنان الذي تم سنة ١٩٨٢ لا تزال بارزةً وكانت مناطق كثيرة قد قسّمت الى محميّات بحيث ان كل واحدة منها تقوم بإدارتها وتولّي أمورها ميليشيات متواجدة فيها، وكان كل فريق على تأهب و حذر من جاره فيما القوات الإسرائيلية تصول وتجول على أغلبها وكأنها السلطة العليا التي يخشاها الجميع!
في تلك السنة، وبسبب الأحداث، كان خط الرياض-بيروت موقفاً الى أجل غير مسمى. فسافرت عبر الدمّام برفقة زوجتي وطفلتي دانة. وكان والداي واخي صلاح لم يتعرفوا بعد عَلى المولودة الجديدة. وبعد الوصول الي بيروت لم يكن بالإمكان قطع المسافة التي تفصل بين المطار وبلدتي براً وكانت لا تزيد على ٢٥كلم. فاضطررنا الى المكوث يومين لاستقلال ما سمّيت لنا بأنها باخرة تحمل اسم “رميش” لقطع المسافة بحرياً من الحوض الخامس في مرفأ بيروت الى مرفأ الشركة الحرارية في الجيّة. وكانت رحلة ذقنا فيها الأمرّين لأن “الباخرة” ما كانت الا قارب يستعمل عادة للصيد في مياه أهدأ مما واجهنا.
بعد المكوث أسبوعين بين ربعي وإذ كنت أهمُّ بالعودة مع عائلتي الصغيرة الى الحوض الخامس عبر مرفأ “الجيّة”، وخوفاً مما قد يحصل للمنطقة، أصرّت والدتي على ان أحمل معي بعضاً من الأواني الفضية الثمينة والتي خصَّنا بها أنا وزوجتي بعض الأقرباء في حفل زواجنا لثلاث سنوات خلت. فوضعت تلك الأواني في كيس من الفلانيلا ذات اللون البيج والذي خُيّط خصّيصاً لحفظ القطع من أضرار الرطوبة.
استقلليت سيارة أجرة أوصلتني مساءً الى المطار بعد ان ودعت زوجتي وابنتي اللتين قررتا المكوث مدة أطول في ربوع لبنان تجنباً لحرّ صيف السعودية. بعد ان انهيت التسجيل ووضعت حقيبتي على سيار العفش، توجهت حاملاً كيسي الى المنطقة المخصصة لإنتظار الإقلاع. وكنت أقول لنفسي أني لن اجد وجهاً أعرفه. وإذ بي أُفاجأ بصديق من آل طعمه يرافقه زوجته وأطفاله الثلاث وكان كبيرهم لا يزيد عمره عن الأربع سنوات. وكنت قد تعرفت على هذا الصديق عبر قريب لي كان يعمل في نفس الشركة معه، وكان لنا بعد ذلك تبادل زيارات عائلية فيما بيننا.
سألني صاحبي ماذا في الكيس الغريب الذي كنت أحمله. فشرحت له القصة وانه يحوي فضّيات ارتأينا أن نأخذها معنا على ان نتركها إذ لا ندري ما سيحصل!
وإذ كنت في غاية الإنفراج مذ لقيت من اتحدث معه، والاّ بِنَا نسمع ان الرحلة قد تأخر إقلاعها ساعة من الزمن. فقلت مازحاً بصوت عالٍ:” أوف! هالميدل إيست عطول بتتأخّر!” فتجهّم وجهه فجأة وكأنه استاء مما قلت وسألني: لماذا تقول ذلك؟ فأجبته انه معروف عن الميدل إيست انها تتأخر. فأجاب : أبداً! لم تحصل معي ولا مرة! قلت له انت محظوظ! الم تسمع ما يروى عن اسم الميدل إيست:
MEA = MISS EVERY APPOINTMENT اي : تٌفوت كل موعد
وكان الناس يمزحون في تلك الأيام فيرددون تسميات حول شركات الطيران المتواجدة آنذاك فيقولون مثلا:
BOAC = BETTER ON A CAMEL
SABENA = SUCH A BLOODY EXPERIENCE NEVER AGAIN
الى ما هنالك…
الا ان صاحبي لم يعجبه حديثي وبقي على أعصابه . وما زاد الطين بلة انهم أعلنوا عن تأخير اضافي لساعتين ! فتوقف الحديث فيما بيننا وطالت الدقائق بانتظار لحظة الإقلاع!
اخيراً طلب منا الصعود الى الطائرة. فكان مقعدي بجوار النافذة فوضعت الكيس تحت المقعد المتواجد امامي. جلس صديقي بجانبي بينما جلست زوجته بجانبه بموازاة الممر. وكان الأولاد الثلاثة يبعطون في حرجٓي والديهم بينما كنت قابعا في ركني حيث كان رأسي يلامس انحدار جدار الشباك من ناحية بينما كان جسمي يحاول ان يبتعد عن حراك الأطفال من الناحية الثانية.
بعد ان شرحت المضيفة تعاليم السلامة اقلعت الطائرة وأخذت ترتفع بقوة محركاتها الى ان وصلت الى الارتفاع المنشود لقطع المسافة المتبقية. فأطفئت إشارات ربط الأحزمة وبدأ بعض الركاب يتحركون منهم للذهاب الى المرحاض او للتفتيش عن مجلة او للتكلّم مع مسافر آخر يعرفه ويجلس في صف مختلف. وانقضت بضع دقائق بدأ خلالها الطاقم الإعداد لتوزيع وجبات الطعام وبدأت خلالها أتنفس الصعداء مقنعاً نفسي ان نهاية المشوار قد قربت وما هي الا ما يزيد قليلا على الساعتين ونحط في مطار الدمام… ألاّ ان إشارات ربط الأحزمة أشعلت مجدداً وجاءت المضيفة لتعلن عودة الطائرة بركابها الى بيروت فيما تبين ان احد المحركات قد توقف عن العمل!
عندئذٍ، أقام صاحبي الدنيا وأقعدها ولعن بصوت عالٍ الساعة التي استقل بها الطائرة برفقتي! ثم قال لي بلغة الآمر:” اسمع. هذا الكيس تنساه. وهذا الولد انت مؤتمن عليه، وتقوم بتخليصه في حال حدوث ما لا يُحمد عقباه! هل فهمت؟” أجبته: نعم.
عادت الطائرة الى بيروت وانتظرنا حوالي ساعتين واستقللنا طائرة ثانية أوصلتنا الى الدمام!
منذ تلك الرحلة لم أر صاحبي ولم اعرف عنه شيئاً وانا متأكد من انه اذا صادفني في أية رحلة سينزل من الطائرة مهما كلّف الامر!
منذ حوالي السنة زارني صديق عزيز من آل الخولي وقال انه التقى الصديق القديم وأخبره بانه سيقوم بزيارتي فطلب منه هذا الأخير ان اخبره بقصة تلك الرحلة!