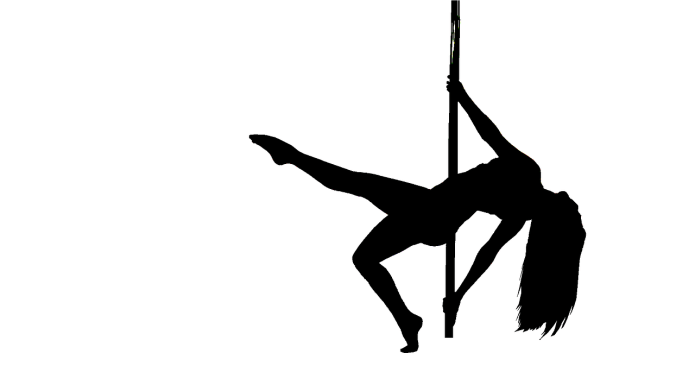في بداية شهر كانون الثاني من سنة ٢٠١٦ استقللت طائرة من زوريخ عائداً الى مونتريال. وفيما كنت جالساً في مقعدي خالجتني خواطر مؤلمة وانتابتني رغبة شديدة بأن أخرج ما كان يقبض على صدري من آثار فاجعة “الباتكلان” والتي كانت قد وقعت لنحو من شهر خلا!
ترددتُ في اختيار اللغة التي سأدوّن بها أفكاري: أأكتب بالفرنسية التي كنت بدأت بها تدويناتي أم بالانكليزيّة التي ألت اليها في آخر الامر؟ ثمّ تساءلت: لمَ لا أكتب بالعربية وبالأخص لأن الشرارة الاولى لما يحدث اليوم كانت قد انطلقت من بلاد العرب؟
بالعربية؟ كيف اكتب بها ولم أقرأ كتاباً عربيّاً واحداً منذ عقود كما لم أكتب أي نص مذ أيام دراستي الثانوية في صف البكالوريا؟
اما اللغة العربية فتذكرني بالفتاة اليانعة الخجولة ذات الجمال الأخّاذ والشعر الأسود القاتم الذي تزنّره طرحة ملونة والتي تجلس على طاولة في مطعم على مقربة منك. تجد نفسك مسحوراً بسواد عينيها وحاجبيها المرسومين بإبداع مبدع! أما الشفتان فحدّث ولا حرج وقد سكبتا في قالب خُصَّت هي وحدها به. ما ان ترمقك بطرف عينها حتى تخال نفسك وقد ملكت الدنيا! تُحضّر بتمعّن كل ما تريد أن تقوله لها من كلام جميل للإستحواذ على انتباهها والفوز بإعجابها ومن ثمّ تنتظر لحظة معيّنة تنتصب فيها من مقعدك وتتوجه نحوها بتأنٍّ وخطى ثابتة وما ان تصل اليها وتنظر الى عينيها وتبادرها باول جملة حتى تتلعثم بالكلام وتنسى النص وتُضيّع على نفسك فرصة لا تُعوّض… هذه هي لغتنا، رائعة في جمالها طالما لم نتلفّظ بها!
كتبت أول نص لي وكان بعنوان “الله والعباد” وذلك تبعاً لما آلمني من احداث كانت قد وقعت خلال الشهر الذي انصرم! كنت خائفاً من ان أكون قد تجاوزت خطاً أحمر لا يجوز تعدّيه فأرسلت ما كتبت الى الاستاذ إميل ديب أستشيره بالأمر! كان الجواب إطراءً بالنص وتحثيثاً على نشر المقال والمتابعة في الكتابة!
وهكذا بدأت أدوّن أفكاري وأخباري باللغة العربية! وتبعت مقالتي الأولى بثانية بعنوان “يا إلهي… أغفر لي صلواتي!”. ومن ثمّ عدت الى ذكريات لي من عالم طفولتي ونشأتي في لبنان. ثم بعد ذلك رويتُ أحداثاً وقعت معي في العراق، وفي السعودية وفِي كندا…
لا يسعني في هذه المناسبة الاّ ان اشكر كل من دفعني الى الاستمرار والمثابرة ونشر الكتاب واخص بالذكر السفير مسعود معلوف، والاستاذ بيار أحمراني، والاستاذ سامي عون، والاستاذ جوزيف شباط، والاستاذ جوزف دورا، والإعلامية كوليت درغام، والإعلامي فكتور دياب ورفيق الطريق الاستاذ الملحن إميل ديب.
اشكر أيضاً الصديق جورج جحا الذي قام بطبع هذه النسخة الورقيّة في مطبعته في “سان لوران” كما الصديق نبيل لحام الذي قام بتصميم الكتاب والصديق جوزيف سكاف الذي توجّب بتحميل النسخة الالكترونيّة على شبكة الانترنت ضمن الكتب المتوفّرة للتحميل عند “أمازون” مع كتب ما يسمّى “بكندل”.