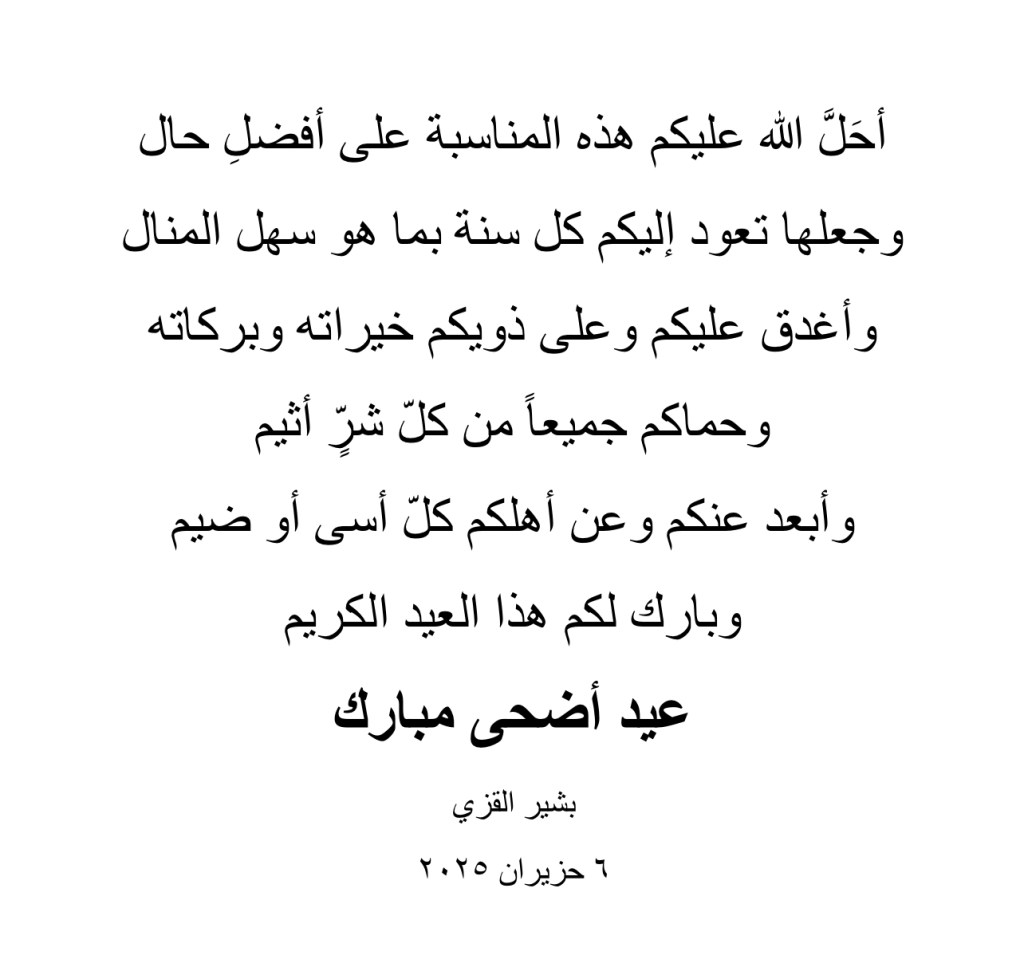
Author Archives: bachir2014
الذكاء الاصطناعي بين الإبداع والهبل
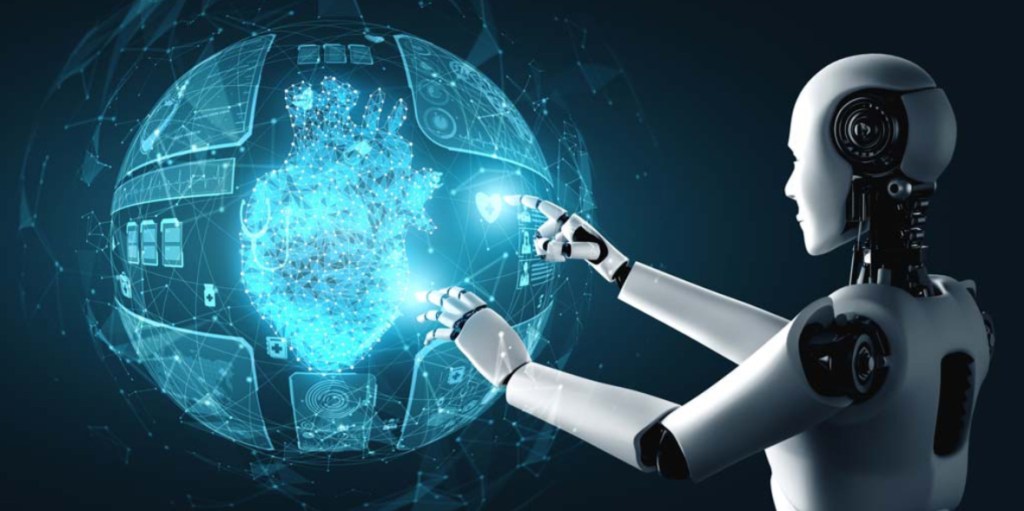
الذكاء الاصطناعي بين الإبداع والهبل
اجتاحت المواقع الإلكترونية في الآونة الأخيرة نصوصٌ مكتوبة باللغة الفصحى أوردها أناسٌ لا يتقنون اللغة الأم، وقد خبِرَهُم القراء على مدى سنوات طويلة واكتشفوا ضعفهم اللغوي إلى جانب الفشل الذريع لدى بعضٍ منهم في شرح ما يقصدون في كتاباتهم! وإذ لجأ البعض منهم إلى الاستعانة بالمولود الجديد، ألا وهو ما سُمّيَ بالذكاء الاصطناعي ، نجدُ أولئك الكتّاب يذيّلون نصوصهم بتوقيع أسمائهم وكأن النص هو من فعلهم، وهم لم يكتبوا أي جزء من ذاك النص، بل اكتفوا بالطلب من الذكاء الاصطناعي ان يكتب مقالاً حول موضوع معيّن!
والأغشم من ذلك كله نجد أولئك الناس الذين يصفّقون لهكذا نتاج، ويعتبرونه من أجمل ما كُتب، ويُحَيّون فِكْر الذي ادعى كتابة النص دون ان يبحثوا عن مصدر ما كُتب ومرجعيته!
وهنا تتوجب علينا المساءلة: أهل الذي استنسخ المقال، واستنجد بالذكاء الاصطناعي لكتابة نص هو أبعد الناس عن التمكّن من صياغته، هو الذي يستحق التصفيق والإطراء، أم ذاك الذي يُهلّل بشكلِ أعمى لشخصٍ لا يعرف لا الكتابة ولا التحليل إنّما يصفّق تقديراً ومبهوراً بنصّ استولدته البراعات الالكترونية ؟
بمناسبة الأعياد الكريمة

بمناسبة الأعياد الكريمة
حيفي بمناسبة هذه الأعياد المباركة على شهداء سقطوا دون اقتراف ذنب، منهم من أصبح في غرار الأموات ومنهم ما زال حيّاً وسيعيش ما تبقّى له من عمر وهو يعاني من آثار ما أصابه…
حيفي على من شُرّدوا وفَقدوا مأواهم ورُحّلوا من مكان إلى آخر تحت آثار القنابل القاتلة،
حيفي على فئاتٍ أغدقت بالموائد على بطونها واعتبرت الكرم موجّهاً لمجالسها، ورمت من فائض إفطارها اكثر مما استوعبت كروشها،
حيفي على كرم العيد الذي لم يأتِ إلّا لحفنة قليلة من البشر، بينما بقي الكثيرون يشتهون الحصول على لقمة يابسة من الخبز تُبعد عنهم جوعهم وجرعة ماء تروي عطشهم،
حيفي على بلدان ادعت المساواة بين البشر بنما هي ابعد الناس عن أيّة مساواة وتزوّد الأشرار بالمواد التي تزيد من بطشها،
وأخيراً…
وفي هذه المناسبة أتمنى لكلّ من يقرأ نصي هذا، ان يكون هذا العيد آخر ما يراه من ظلمٍ وافتراء في دنيانا وان يكون الكرم في الأعياد المقبلة متجلّيا بروح المحبة والإخلاص لكلّ ما خلقه الله على هذه البسيطة…
ونطلب الخير والوئام لكم ولعائلاتكم في الأعياد المقبلة.
بشير القزي
مونتريال في ٣٠ آذار ٢٠٢٥
من ذكريات عقد قراني (الجزء التاسع)

من ذكريات عقد قراني (الجزء التاسع)
في اليوم التالي غادرتُ الفندق برفقة عروسي باتجاه مطار بيروت حيث استقللنا طائرة أقلّتنا إلى روما. وصلنا قبل غروب الشمس وما ان خرجنا إلى باحة المطار الخارجية حتى صادفتُ إحدى سيّارات الأجرة فطلبت من السائق ان ينقلنا إلى أحد الفنادق في وسط المدينة. في تلك الأيام لم تكن بعد قد وصلت تقنيّة الحجوزات بواسطة الانترنت، أما التواصل عبر الهواتف فكان شبه معدومٍ وبالأخص مع لبنان!
أوصلنا السائق إلى جادة جميلة في وسط المدينة تحمل اسم “ڤيّا كواترو نوڤمبري” وانزلنا أمام فندق تتماشى هندسته مع المباني التاريخية التي تحيط به! اخترنا إحدى الغرف الجميلة وخلدنا إلى النوم ولم نستفق حتى صباح اليوم التالي حيث قصدنا مطعم الفندق لتناول وجبة الفطور.
كنا الضيفين الوحيدين اللذين يتناولان الفطور في الوقت الذي قصدنا فيه المطعم. كانت نادلة إيطالية متوسطة العمر تقوم بالخدمة، إلّا أنها لم تكن تفهم إلّا الإيطالية. حاولت إفهامها ما نريده، إلّا ان إفهامها بدا كمهمّة مستحيلة رغم محاولتي لفظ الكلمات الإنجليزيّة او الفرنسية باللّكنة الإيطالية! وإذ كنت أحاول عبثاً إفهامها ما نريده، دخلت عائلة سعودية المطعم، مؤلفة من أربعة اشخاص، وجلست على إحدى الطاولات! توجه الأب نحو النادلة قائلاً باللغة العربية العامية: “آبي بيض عيون” وإذ بها تزوّده بما يريد خلال دقائق ونحن ما زلنا في حيرة من أمرنا! فهمتُ آنذاك أنّ إفهام بعض الناس قد يكون أبسط ممّا نتخيّل!
وإذ تعوّدنا في بلادنا أن وجبة الطعام الرئيسية هي وجبة الظهيرة، قصدنا ظهر ذاك اليوم مطعماً يحمل إسم “بيتزا”. إلّا أني فوجئت بأن “الطليان”، في ذاك الزمن، لا يأكلون البيتزا مع وجبة الغداء بل يأكلونها مع فطور المساء!
عدنا إلى المطعم نفسه مساء ذاك اليوم! استقبلنا النادل الذي بدا في الستين من العمر بلائحةِ الوجبات المتوفرة، إلّا أنها كانت مكتوبة بالإيطالية. وإذ لم أرد الإطالة في البحث عمّا سأطلبه، تذكّرت أننا كنا في بيروت نطلب “بيتزا نابوليتانا” في مطعمي “بوبي” أو”أستيريكس” اللذين كانا يقعان في منطقة الروشة. فما أن طلبت “بيتزا نابوليتانا” حتى حدّق بوجهي النادل وصرخ غاضباً: “تذهب إلى “نابولي” لتأكل بيتزا نابوليتانا، أمّا هنا فتطلب بيتزا رومانا!” قلت في نفسي: “إذا لم يكن ما تريد، فأرد ما يكون!” لذا رضيت “ببيتزا رومانا” تفاديا لمشكل كاد ان يشتعل!
صباح اليوم التالي وجدت صحيفة دعائيّة مكتوبة بالإيطالية لدى كاونتر الاستقبال. أخذت نسخة وتوجهت نحو الغرفة وبدأت اتصفّحها. وإذ كنت أقلّب الصفحات وقعت على دعاية لمطعم يحمل اسم “دا ميو باتاكا” وهو مطعم يذكرني بمطعم يحمل الاسم عينه في منطقة الحمرا في بيروت. أذكر أنّي ترددت على ذاك المطعم زهاء السنتين قبل ان أتمكّن من حفظ اسمه! غيّبت عنوان المطعم وقلت لميشا: “هيّا بنا لتناول وجبة الغداء!” (طبعاً لم أعلمها عن المطعم)
طلبت سيارة أجرة وبعد ان صعدنا قلت للسائق:
Trastevere, Piazza Mercanti, Da Meo Pataca Restaurante
انطلق السائق بالسيارة ولم يسألني أي سؤال وكأنه فهم ما طلبته منه! وإذ بنا ندخل مناطق لم ندخلها من قبل، جنّ جنون عروسي وقالت لي:” كيف تتكلّم بالإيطالية؟ يبدو انك أتيت إلى هنا من قبل!”
وكلما دخلنا إلى امكنة لم نزرها من قبل كان الفضول يدخل قلب زوجتي بينما كان الفخر ينفخ رئتيَّ! في النهاية دخلنا ساحة للمشاة تكسو أرضها الأحجار المبلطحة. توقف السائق لينزلنا وأشار بيده اليسرى إلى الخارج قائلاً: دا ميو باتاكا رستورنتي” دفعت الأجرة ونزلنا لنجد ان الكراسي في المطعم مرفوعة فوق الطاولات وهو مقفل لا يفتح إلّا للمساء!
حاولنا أخذ سيارة أجرة، إلّا اننا لم نتمكن من إيجاد أي منها! مشينا في طريق العودة ما يزيد على الساعة حتى وجدنا مطعماً جاهزاً لاستقبال الزبائن!
من ذكريات عقد قراني (الجزء الثامن)

من ذكريات عقد قراني (الجزء الثامن)
يصدف صدور الجزء الثامن من ذكريات عقد قراني مع مناسبة عيد العشق الذي يتمّ إحياؤه في أغلب بلدان العالم!
ما ان شرعتُ بكتابة النص حتى تذكّرت كيف اختفى اللون من وجهي عندما أعلمني المسؤول عن الحجوزات بأنه لا يوجد لدى الفندق أيّ حجز لغرفة باسمي! كانت الشمس قد قاربت على الاختفاء وراء أفق البحر ولم يكن بمقدوري التكهّن أين سأقضي ليلتي الأولى مع عروسي! هل سأذهب وأدقّ على أبواب الفنادق لأجد غرفة فارغة نبيت فيها تلك الليلة؟
ثمّ تراءى لي أن أسأل ذاك المسؤول: “هل هذا يعنى أن كلّ الغرف ملأى بالزبائن ولا توجد أيّة غرفة فارغة؟” أجاب: “لا! لدينا غرف فارغة إنما لا توجد غرفة محجوزة باسمك!” عندئذٍ خَفَّتْ حدّة توتّري فانتقيت إحدى أفضل الغرف المتوفّرة لديهم. ما ان تمّ نقلنا إليها مع أمتعتنا حتى ارتمت ميشا بثيابها على السرير ووقعت في سبات عميق من كثرة الإرهاق ولم تستفق حتى صباح اليوم التالي!
لدى استيقاظنا اتصلتُ بالخدمة وطلبتُ إحضار القهوة مرفقة بالترويقة لكلينا. وما ان تمّ استحضار الطلبيّة إلى الغرفة وبدأنا بارتشاف القهوة إلى جانب تناول الترويقة حتى رن هاتف الغرفة. رفعتُ السمّاعة وإذ تجيبني على الطرف الثاني “ريموند”، أخت “ميشا”. كانت برفقة ابنة خالتها “فوفا” وصديقتها “فاديا”. قالت نحن في الفندق وقد أحضرنا لكما ترويقة كنافة بالجبن!
بعد ان تناولنا الكنافة جلسنا لارتشاف القهوة على المقاعد البحرية حول المسبح وكانت الفتيات قد ارتدين البسة السباحة. وما كنّا نتأمّل المنظر البديع للجبال المطلّة والتي تنحدر نحو الشاطئ الذي يحيط به البحر الجميل بلونه وأمواجه حتى سمعنا أصوات طائرات حربيّة تحلّق على علوٍّ منخفض. وفجأة اندلعت أصوات مدافع رشّاشة مضادة للطائرات مركّزة على مقربة من المكان الذي كنّا نجلس فيه! ارتبك الجميع وهمّ المتشمّسون بالفرار بمختلف الاتجاهات. أمّا زائراتنا فكنّ على عجلة اكثر من غيرهنّ خوفاً من ان تقفل الطرقات!
بعد ظهر ذاك اليوم حضر والدايَ برفقة أخي صلاح وقام الجميع بتقديم التهنئة مجدّداً لنا. وإذ كنّا نهيّء نفسنا للسفر في اليوم التالي إلى روما لتمضية “شهر العسل”، قمتُ بتسليم السيارة التي حضرنا بها إلى أخي صلاح.
ذاك المساء قصدنا الملهى الموجود في ذاك الفندق. كان الحضور ضعيفاً رغم الموسيقى الصاخبة التي كانت تملأُ الأجواء. أمّا ما كان يثير عدم الارتياح فكان وجود رجلين، كلٌّ على طاولة مستقلّة، يبدو كلٌّ منهما وكأنّه تابعٌ لفرع المخابرات! لم نمكث طويلاً في الملهى وعدنا الى الغرفة بانتظار السفر في اليوم التالي.
أمّا ما حدث خلال السفرة فساسرده في الجزء التاسع من الذكريات…
من ذكريات عقد قراني (الجزء السابع)

من ذكريات عقدِ قراني (الجزء السابع)
في اليوم الذي سبق التاريخ المعلن لحفل الزواج، قامت إسرائيل بالإغارة بطائراتها الحربيّة على مداخل بيروت الجنوبيّة كما تسبّبت بقطع التواصل على خمسة جسور قامت باستهدافها بتلك الغارات، كما قضى نحبه أناس أبرياء يُعدّون بالمئات!
وإذ كانت تلك العمليّة باكورة أعمال عدائيّة ضخمة بدأت آنئذٍ ولم تنتهِ حتى يومنا هذا، استفاق لبنان في اليوم التالي والوجوه قد تجهّمت والمحال قد أُقفلت بغالبيتها وحركة السير تعكّرت. كانت ميشا تسكن مع والديها في بلدة “عين علق” القريبة من مدينة “بكفيا”، بينما كنتُ اسكنُ مع والديّ في بلدة “وادي الزينة” القريبة من بلدة “الرميلة” حيت ستجري مراسم الزواج! ذاك الصباح لم يكن بالإمكان الحصول على ورود وأزهار، لتزيين الكنيسة، من مدينة “صيدا” القريبة نظراً للحالة المستجدة!
غدت والدتي باكراً واستقلّت السيارة المعدّة للزفاف ورافقها بعض الأقارب بسيّاراتهم وسلكوا طرقاً فرعيّة عبر الجبال لتجنّب الطريق الساحلي الذي يربط بين المنطقتين والذي كان يعجّ بالمسلّحين الذين كان الغضب مستشرياً في عيونهم!
بعد سفر استغرق زهاء ثلاث ساعات وصلت والدتي برفقة الوفد المرافق لها إلى منزل العروس وكان يعجّ بالمحتفلين! كنا قد تعاقدنا مع مصوّرين اثنين لالتقاط الصور والفديوهات للحفل بدءاً من منزل ميشا وانتقالاً إلى مراسم الزفاف في الكنيسة ومن ثمّ حفل الكوكتيل في منزل والديّ، إلّا أنّ المصوّرين عكفا عن متابعة المهمّة خوفاً من أخطار الطريق والالتقاء بالجماهير الغاضبة! أما والدتي فطلبت جمع الازهار الموجودة في البيت ووضعها في صناديق السيّارات وعدم تزيين سيّارة العروس بأية زهرة!
وإذ كنتُ أشكُّ بإمكانية وصول العروس ذاك اليوم، لم أحلق ذقني وبقيت أرتدي ثياب الانشراح التي ارتديتها في الفراش تلك الليلة! إلّا انه، قرابة الظهر، وصل متعهّد الاحتفال مع فريقه من بيروت وفد حمل معه مستلزمات الكوكتيل كافة من الكيك المتعدد الطبقات والحلويات المنوّعة ومجمل الضيافات المعدّة للحفل، وكنا قد جهّزنا عدداً لا بأس به من زجاجات الشمبانيا المبرّدة! وما ان بدأ المتعهد، وهو من أحد الأقارب، بترتيب صالة السفرة للإحتفال حتى بدأ وصول بعض الأصدقاء المدعوّين إلى المنزل! عندئذٍ انتابني الخجل، كلّ الحاضرين يرتدون أفضل ما لديهم من ثياب وأنا ما زلت في “البيجاما”!
قمتُ بحلاقة ذقني وارتديت بدلة السموكنغ السوداء التي أعددتها للزفاف كما ربطت ربطة عنق بيضاء فراشيّة الشكل! وما ان فرغت من ارتداء ملابسي حتى سمعت أصوات زمامير سيارات الوفد المرافق للعروس، وقد وصلت قبل زهاء الساعة قبل موعد الزفاف!
توجّهت العروس نحو منزل عمتها الذي كان يقع على طريق شحيم القديمة على بعد نحو ثلاث ماية متر من طريق صيدا القديم، وذلك بانتظار موعد الزفاف. وإذ وصلني خبر عدم وجود مصوّر مع العروس أرسلت أحد الأقارب إلى بلدة الجيّة حيث تمكّن من إحضار أحد المصوّرين الأقارب لتصوير وقائع الزفاف، وزوّدته بكاميرا سينمائية سوبر ٨ لتصوير بعض المشاهد!
توجّهت مع بعض الأصدقاء نحو كنيسة الرميلة وهي تقع على تلة مرتفعة تطلّ على شاطئ الرميلة الرملي والذي يحتضن البحر الذي يدخل نحوه بشكل خليج منفتح. المنظر الذي كنت أراه يومئذٍ من أجمل ما شاهدت!
وصلت العروس وبجانبها والدها. نزل من مقعده، دار حول السيارة وفتح الباب لها وأمسك بيدها وانزلها ثم قدمها لي وقال: “ها هي سالمة! هي في عهدتك بعد اليوم!” كانت ترتدي طرحة بيضاء ناعمة فوق رأسها، أما فستانها فكان من أجمل ما رأيت!
مددتُ لها يدي اليمنى ودخلنا باب الكنيسة من المدخل الرئيسي المواجه للبحر، وكنت من ناحية اليسار، إذ قيل لي انه لدى الموارنة تكون العروس من الناحية اليمنى!
كانت الشبينة أخت ميشا ريموند بينما كان الشبين أخي صلاح. بعد انتهاء حفل الزفاف وأخذ الصور توجهنا نحو المنزل للاحتفاء وقبول التهاني!
وإذ كنت قد طلبت من ابن عمي هاني حجز غرفة لنا في فندق السمرلاند على شاطئ بيروت، توجّهت مع عروسي نحو بيروت بسيارة أخي صلاح التي كانت حمراء اللون من نوع رينو ٥. كان علينا ان نسرع قبل ان يداهمنا الظلام.
ما ان وصلنا إلى السعديات بالقرب من منزل آل غفري حتى اضطررنا إلى النزول بالسيارة في حفرة كبيرة من آثار القصف الذي حدث في اليوم الذي سبق!
وصلنا أخيرا إلى الفندق وتوجهت إلى الاستقبال وسألت المسؤول عن الحجز الذي تمّ باسمي! فوجئت بجوابه:” آسف، لا يوجد حجز باسمك!”
أما ما حصل بعد ذلك، فسيكون بالجزء الثامن من الذكريات…
كلمة في رحيل والدة سارة

عزيزتي سارة
مع ان رحيل والدتك تيريز آلمني كثيراً إلا ان الكلمات التي خطّيتِها إثْرَ وفاتها كان لها بالغ الأثر عليَّ وعلى كلّ من يقرأها! محظوظات هنّ الأمهات اللواتي يحظين بهكذا كلمات لدى حلول ساعتهنَّ!
ها هي ودّعت عالماً عاشته بحذافيره وقد غادرته في بداية سنة جديدة ينتظرها ويستقبلها كثيرون! لقد سهرت على تنشئة بناتها وابنها على أفضل السبل ولقّنتهم أفضل تربية وربّتهم على خير القيم الدينيّة! وفّقها الله ايضاً في ان تشهد على تربية أحفادها وها هي ترحل بعد ان شاهدت باكورة ظهور أحفاد أولادها!
ها هي تسلّمكِ وتسلّم أختيكِ وأخاكِ الراية التي حملتها طوال حياتها! من الآن فصاعداً على كلٍّ منكم ان يكمل المشوار ويلعب ما تمكّن الدور الذي خطّته لكلٍّ منكم!
بالنيابة عن زوجتي ميشا وابنتي دانة وعائلتها وبالأصالة عن نفسي أتقدّم منكِ ومن أخيكِ عيسى ومن أختيك وأفراد العائلة كافة بالتعازي الحارة النابعة من الصميم وأضرع إلى الله ان يبعد عنكم جميعاً كلّ مكروه!
بشير القزي
مونتريال في ٤ كانون الثاني ٢٠٢٥
كلمة في رحيل خالي نبيه

خالي الحبيب نبيه،
صُعقتُ بخبر رحيلك المفاجئ وانت الإنسان الذي ما زالت تحلو له الحياة كما يستمتع بوجودك كلّ من جلس في حضرتك! كنت أتمنّى ان تسنح لي الظروف بأن أعود إلى بلدي الأم لرؤيتك والجلوس بجانبك!
كنتَ من أوّل الناس الذين عرفتهم في صغري والذين كنت أعتبرهم من أقرب الأشخاص إلى قلبي! أذكر أني كنت في الثالثة من عمري عندما كنتَ تُداعبني وتحملني على رجليك وترفعني إلى الأعلى وانا أغرق في بحر من الخوف والضحك! بعد وصول الأسطول السادس إلى الشاطئ اللبناني سنة ١٩٥٦ أذكر أنك أخذتني إلى محلات “قيصر عامر” للألعاب في بيروت واشتريت لي “جيب” حديدي زيتي اللون وعليه نجمة بيضاء وقد تمتّعتُ بقيادته حتى أصبحت رجلاي لا تتسعان للجلوس بداخله!
أذكر أيضاً أنك أهديتني ساعة يد ماركة “إكزاكتوس” وكنتُ وقتئذٍ في السابعة من عمري وأتعلّم في مدرسة “كليّة لبنان” التي كانت تقع في محلّة البسطا. لصغر رسغي أضفنا عدّة ثقوب على الرابط الجلدي حنى اتمكّن من لبسها! كنتُ الوحيدَ بين أترابي الذي يلبس ساعة على يده! وقد رافقتي تلك الساعة حتى أنهيت تعليمي وتمّ إرسالي إلى العراق للعمل هناك!
عرفتكَ رجلاً قلّ أمثاله وتمتّعتَ بمقدرة عالية في التحدّث والمناقشة وكنتَ توازي المحامين في اختيار كلماتك! كم تمنّيتُ لو سنحت لي الظروف أن أكون بجانبك لأتعلّم منك بعضاً مما تجيده!
ها أنتَ تغادر عالمنا ولا تحمل معك جواز سفر أو حقيبة تحمل متاعك! إلّا أن ذكرَك الطيب سيبقى يتردد عبر كلّ من عايشك أو عرفك!
بالنيابة عن زوجتي ميشا وابنتي دانة وعائلتها وبالأصالة عن نفسي أتقدّم بالعزاء الحار من أخيك آمال ومن زوجتك التانت بريجيت التي رافقتكَ على مدى العقود ومن أبنائك إيلي وأمين وزياد ومن ابنتك زهى وعائلاتهم وأولاد أخوتك وعائلاتهم والاقارب الكثر الذين عرفوك وأحبّوك ونضرع إلى الله أن يحفظ الجميع ويبعد عنهم كلّ مكروه!
بكل محبة
بشير القزي
مونتريال ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤
من ذكريات عقد قراني (الجزء السادس)

من ذكريات عقد قراني (الجزء السادس)
بعد حفلة الخطوبة التي تمّ إجراؤها في الرياض، قرّرنا أن يكون عقد القران في ١٨ تمّوز من تلك السنة، وهي سنة ١٩٨١ على ان تكون المراسم في كنيسة البلدة التي انتمي إليها، وهي الرميلة والتي تقع على الطريق المؤدّية من بيروت إلى صيدا، وهي آخر بلدة نلقاها قبل الوصول إلى نهر الأوّلي الذي يفصل بين محافظتي جبل لبنان والجنوب.
ما مضى أسبوعان من الزمن حتى قررت ميشا السفر إلى باريس برفقة أختها وذلك للتبضّع بكلّ ما يستلزم من أمور الجهاز. أمّا الجهاز فكان أمراً مهماً تُعدّ له كل فتاة قبل مراسم زفافها وهو يشمل جميع المستلزمات التي قد تحتاج إليها العروس ما ان تنتقل للعيش في منزلها الزوجي، وهو يشمل بالإضافة إلى الملابس التي سترتديها أطقم الشراشف والمناشف والأحرمة والخدمة والاستقبال وما إلى هنالك من أمور قد تحتاج اليها في حياتها الجديدة! وأذكر في صغري أن العادات كانت تقتضي أن تعرض الفتاة الجهاز في منزل أهلها في يوم معيّن ويقوم رتلٌ من الأقارب بواجب الزيارة وذلك للتفرّج عليه!
أمّا فستان العرس فكانت له مكانة خاصة لدى ميشا وكانت تريده بالشكل الذي كانت رسمته في ذهنها، لذا أصرّت على أن يحمل التصميم والتفاصيل التي ارادتها! وقد حملته بيديها ضمن علبة كرتونيّة بيضاء خاصة على متن الرحلة التي استقلّتها ولم اتمكّن من رؤيته الّا نهار العرس!
قبل حوالي أسبوعين من تاريخ الزفاف توجهنا بالطائرة نحو بيروت. أقامت ميشا مع والديها في منزل العائلة في بلدة عين علق في المتن بينما أقمت في منزل والديّ في بلدة وادي الزينة التي تقع على طريق صيدا القديمة.
مساء الأحد الذي كان يسبق بأسبوع موعد الزفاف، دعوت ميشا الى العشاء في مطعم “وأي نات” في مدينة برمّانا المتنيّة. كانت قد صففت شعرها لدى مصفف شعرٍ نسائي، ما لم يكن متوفّراً في الرياض كما ارتدت فستاناً بيجيّاً قصير الأكمام وله فتحة من الخلف تقفلها أزرار كبيرة وقد كان بين ما تسوقته في باريس. وكانت قد وضعت حول عينيها كحلة سوداء وألّقت شفتيها بحمرة مميّزة زادت من جمالها.
وصلنا إلى المطعم في حدود الساعة الثامنة والنصف مساءً. نزلنا على الدرج المبنيّ من الحجر حتى وصلنا إلى باحة المطعم. كان المطعم مبنيّا من عقدين حجريّين يجتمعان في الوسط غارقٍين تحت الأرض وكان أحد الأركان يستعمل كباحة للرقص تحتلّ إحدى زواياه غرفة زجاجيّة يجلس فيها “الدي جي” للتحكّم بالموسيقى وانتقاء الأغاني. أمّا باقي الأركان فكانت للطاولات الخشبيّة والمقاعد المغطّاة بطراريح صوفيّة ملوّنة.
وإذ لم نجد أحداً من الزبائن قد وصل بعد، سألنا المسؤول عن السبب، فأجاب أنهم يبدأون بالوصول بعد ساعة من ذاك الوقت. طلبنا ان نحجز طاولتنا إذ لم يكن متوفّراً في ذاك الزمن الحجز بواسطة الهاتف ولم يكن قد وصل بعد الهاتف الخليوي.
كلّما اشرنا إلى طاولة من الأماميّات كان المسؤول يجيبنا أنها محجوزة! بالأخير اضطررنا إلى الموافقة على حجز طاولة في الأماكن الخلفية للمطعم! وإذ كان المكان لم يعج بعد بالزبائن قلنا له اننا سنعود بعد زهاء ساعة من الزمن!
خرجنا إلى الشارع الرئيسي حيث تنزّهنا على الجانب الغربي من الطريق وكانت المطاعم تعجّ بالزبائن الذين يتألّقون بالملابس الزاهية التي يرتدونها! دخلنا أحد المقاهي وطلبنا مقبلات بانتظار ان يحين وقت عودتنا إلى المطعم.
وصلنا إلى “الواي نات” في حدود الساعة العاشرة مساءً. كان المكان لا يزال خالياً من أيٍّ منّ الزبائن وكان “الدي جي” مسترسلاً بالحركات مع الأغاني التي يختارها وقد وضع السماعات الكبيرة فوق أذنيه! سألنا المسؤول عن سبب تخلّف الزبائن عن الحضور فأجاب مؤكداً أنهم سيصلون بعد حين!
قمنا بالتمركز على الطاولة التي أرادوها لنا. حضر النادل الموكلُ بالقيام بخدمتنا. كان يرتدي سترة رسمية نبيذية اللون فوق قميص أبيض وعقدة حريريّة سوداء على شكل فراشة. أودع بين يديّ لائحة بالمشروبات التي يعرضها المطعم. بدأت بالتمعن بالقراءة واخترت نوعاً من أفضل ما يبدو على تلك اللائحة، وذلك بالأخصّ لأن ذاك العشاء كان الأول الذي أدعو فيه ميشا إليه في لبنان! غاب النادل بضع دقائق ثمّ عاد ليعلمنا أن ذاك الصنف لم يكن متوفّراً ذاك المساء! أعاد لي اللائحة وطلب مني اختيار نوع آخر. أخترتُ ما تلا ذاك النوع فتوجّه نحو المطبخ ليعود ويخبرني أن ذاك النوع قد نفذ. أمّا النوع الثالث فلم يكن متوفّراً أيضاً. توجّهت نحوه بامتعاض وقلت له: “لماذا تُخيّرني بما ليس لديك، أعطني ما هو متوفر ذاك المساء!”
أحضر زجاجة مما أوجده وفتح الفلّينة بتقنيّة عالية وسكب لي مقداراً قليلا لتذوّقها. وافقت على المشروب فقام بملء كأس ميشا ثمّ أكمل سكب كأسي.
وبينما كنت اشتفُّ الكأس بجانب ميشا كانت نقطة ماء تتساقط بين الحين والآخر من السقف الحجري وتقع على رقبتي داخل قبّة قميصي. كنت مستاءً من ذاك المقعد ولم يكن بإمكاني ان أغيّره لأن باقي الأماكن محجوزة (حسب زعمهم).
أحضر لي لائحة الطعام فبعد ان استشرت ميشا طلبت صحن “شاتوبريان” المُعد لشخصين! صعقتُ مجدّداً عندما عاد بعد دقائق ليعلمنا ان تلك الوجبة لم تكن متوفرة ذاك المساء. طلبت منه ان يعلمني بما كان متوفراً وهكذا كان!
بعد ان تناولنا الوجبة الرئيسية طلبت من ميشا ان ترافقني برقصة إلا انها لم ترغب كوننا كنا الوحيدين الموجودين في ذاك المطعم برفقة “الدي جي!”
ما ان أحضر النادل صحنَي الكيك المتوفرين لدى المطعم كانت ميشا قد غفت على كتفي. قمتُ بدفع الحساب ثمّ أيقظتها من سباتها وعدنا أدراجنا إلى منزلها، ولم نعد مرة ثانية إلى ذاك المكان!
أمّا فيما حصل بعد ذلك فبانتظار الجزء السابع من الذكريات …

